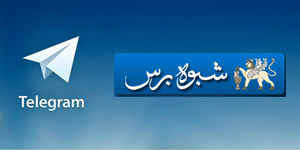تأريخ الجنوب
سلفية وإخوانية أم أحزاب سياسية؟

يكتب أحدهم مدعيا تمثيل التيار السلفي، فيقول إن السلفية الجهادية ليست سلفية، وإنما "إخوانية قطبية"، وهي ليست كذلك بالطبع، وإن تبدى في خلفية أفكارها بعض حضور لسيد قطب. ثم يضيف إن السلفية التي تنادي بتحريم المظاهرات والأحزاب وترفع شعار "من السياسة ترك السياسة" وطاعة ولاة الأمر ما أذنوا بإقامة الصلاة، هي أيضا ليست سلفية، ثم يطلق عليها أسماء متعددة من بينها "الجامية" وأحيانا "المرجئة".
"
خلال الألفية الجديدة بات التيار السلفي واحدا من أهم مكونات الحياة الدينية والسياسية في العالم العربي، وأصبح الأمر أكثر وضوحا في مرحلة الربيع العربي
"
رموز الفرقة الأخيرة (دعاة طاعة ولاة الأمر) يعتبرون أنهم وحدهم ممثلو السلفية الحقيقية، وأن الجهادية لا تمت إلى السلفية بصلة، تماما كما هو حال السلفية الإصلاحية إن جازت التسمية، والتي تنخرط في العمل السياسي الإصلاحي، وهم مثلا لا يعتبرون سلمان العودة ولا سفر الحوالي (عافاه الله) من السلفيين، فضلا عن جماعة إحياء التراث في الكويت ومثيلاتها. ولك أن تمد ذلك إلى رأي الجهاديين في الطرفين المشار إليهما.
خلال الألفية الجديدة بات التيار السلفي واحدا من أهم مكونات الحياة الدينية والسياسية في العالم العربي، وأصبح الأمر أكثر وضوحا خلال مرحلة الربيع العربي، من خلال الثورات وبعد انتصار بعضها، ورأينا حالة سيلان كبيرة في المواقف بين أعضاء هذا التيار ومكوناته.
وبينما يمكن القول إن بالإمكان تقسيم التيار إلى ثلاثة مكونات أساسية: تقليدي، وإصلاحي، وجهادي، لا ينفي ذلك وجود تباينات داخل هذه الفروع ذات صلة بالرموز والمرجعيات والخلافات، وربما الاجتهادات السياسية وغير السياسية أيضا.
خلال الثورات وقعت هزة كبيرة للتيار، إذ رأينا أناسا من التيار "التقليدي" المنادي بطاعة ولاة الأمر ونبذ الفتن ورفض المظاهرات والأحزاب، يتحولون إلى مساندين للثورات، ثم رأينا بعضهم ينخرط في العمل السياسي بعد انتصارها. كما رأينا جهاديين يتركون مسارهم القديم نحو انخراط في العمل السياسي (ليبيا مثالا)، مع العلم بأن شيئا من ذلك حدث قبل الثورات من خلال المراجعات الشهيرة في ليبيا وقبلها مصر، وربما في دول أخرى بهذا القدر أو ذاك، دون أدبيات منشورة بالضرورة.
وبينما تقل -ولا تنعدم- معالم الخلاف في مسائل الاعتقاد، وبدرجة أقل قضايا الفقه العادية، بين هذه المجموعات التي تنهل من ذات المرجعية، يبدو التباين في قضايا العمل السياسي أو العام جليا، مما يدفع إلى القول إن الأخيرة ليست محسومة، وهي أقرب إلى تقدير المواقف والموازنة بين المصالح والمفاسد منها إلى الأحكام المحسومة.
والظاهر أن هذا الأمر ليس وليد اللحظة الراهنة، بل هو كذلك منذ القرون الأولى، ومثال ذلك مسألة الطاعة لولاة الأمر التي لم تكن في جوهرها سوى موازنة بين المصالح والمفاسد في عرف العلماء، وبالطبع حين أنتجت محاولات الخروج على الحكام الكثير من الفتن والدماء. دليل ذلك أن الجدل بشأنها لم يُحسم في يوم من الأيام.
"
في ضوء المخاض التاريخي في المنطقة، فإن أحدا لن يكون بمنأى عن تغيير الأفكار والبرامج، فضلا عن الخلافات والانشقاقات لأن التنظير شيء وحقائق الواقع شيء آخر
"
اليوم وبعد الربيع العربي تراجع إلى حد كبير فقه الطاعة شبه المطلقة للحاكم، بينما تقدم فقه الإنكار السلمي، وتبعا له فقه العمل السياسي الإصلاحي (التعددي). أما الفقه الجهادي فظل حاضرا، إذ تراجع إثر الثورة التونسية والمصرية واليمنية (السلمية)، قبل أن يعود من جديد إثر الثورة الليبية ومن ثم السورية.
في ضوء هذا المخاض التاريخي في المنطقة، والذي لا يخصُّ التيار السلفي، بل يشمل سائر التيارات الفكرية والسياسية وفي مقدمتها الإخوانية (تباينت سياساتها بشكل جلي بين فرع وآخر، قبل الثورات وبعدها)، يمكن القول إن أحدا لن يكون بمنأى عن تغيير الأفكار والبرامج، فضلا عن الخلافات والانشقاقات، لأن التنظير شيء وحقائق الواقع شيء آخر، وعلى الجميع أن يتواضعوا في ادعاء امتلاك الحقيقة، مع الحرص على تجنب استخدام العنف في فرض الرأي.
تذكرنا ذلك كله بين يدي الأزمة التي وقعت بين مؤسسة الرئاسة في مصر والإخوان من جهة، وبين حزب النور السلفي من جهة أخرى (انتهت بسلام كما يبدو)، حيث دأبت بعض وسائل الإعلام على توصيف الأزمة على أنها بين السلفيين وبين الإخوان أو الرئيس، مع أنها ليست كذلك إذا توخينا الدقة، فكما خرج حزب الوسط مثلا من حاضنة الإخوان، فإن حزب النور خرج من الحاضنة السلفية، لكنه لا يمثلها جميعا، ولا يعني الخلاف معه خلافا مع عموم السلفيين (بعضهم لا ينخرط أصلا في العمل السياسي).
في مصر على سبيل المثال، نحن اليوم أمام عدد من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية (16 حزبا بين مرخص وتحت الترخيص، تسعة منها ذات مرجعية سلفية)، لكنها تتباين في تقديرها للمواقف السياسية، والخلاف مع أحدها لا يعني بالضرورة خلافا مع عموم التيار الذي تنتمي إليه. دليل ذلك أن حزب النور نفسه انشق وخرج منه حزب الوطن، فهل يمكن نزع صفة السلفية عن الأخير مثلا، أم هو تباين المواقف بين الرموز والمرجعيات، فضلا عن الخلافات الشخصية؟
هل يمكن القول إن الخلاف بين عبد المنعم أبو الفتوح -وحزبه "مصر القوية" الآن- والإخوان كان خلافا على المرجعية الفكرية مثلا؟ وهل يمكن قول ذلك أيضا بشأن الخلاف بين حمادي الجبالي وبين رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، أو بين الأخير وبين الشيخ عبد الفتاح مورو؟ ولك أن تمد هذه النظرية على معظم الدول العربية التي تتوفر فيها أحزاب تلتقي في المرجعية الفكرية، لكنها تتعدد وربما تتصارع في الميدان السياسي (يوجد مثل ذلك عن العلمانيين واليساريين والقوميين).
قبل ذلك كله، هل كانت الخلافات السياسية التي سادت منذ آخر ولاية الخليفة عثمان رضي الله عنه والقرون التالية خلافات حول المرجعية الفكرية، أم هي العصبيات والصراعات الشخصية في أكثر الأحيان؟!
"
التدافع السياسي والفكري قدر هذا العالم العربي في زمن الإعلام المفتوح، ومن حق كل أحد أن يتقدم للناس بما لديه.. هذا هو مسار المستقبل
"
لذلك كله، يبدو أن على الجميع الإقرار بمرجعية الأمة التي لا تتعارض بالضرورة مع المرجعية الإسلامية، وعلى كل طرف أن يقنع الناس برؤاه وبرامجه عبر الوسائل السلمية. وفي آخر رسائله طالب أسامة بن لادن مريديه أن يتجنبوا الصدام مع الأوضاع الجديدة الناتجة عن الثورات، وأن ينشغلوا بإقناع الناس برؤاهم عبر الدعوة.
والرؤى التي نعنيها هنا لا تخص السياسة فحسب، بل تشمل القضايا الدينية أيضا بعيدا عن لغة التكفير والإقصاء، مع حق كل طرف في القول إن رأيه هو الأكثر صوابا والأكثر تعبيرا عن جوهر الدين.
التدافع السياسي والفكري قدر هذا العالم العربي في زمن الإعلام المفتوح، ومن حق كل أحد أن يتقدم للناس بما لديه. هذا هو مسار المستقبل الذي لا مناص من التعامل معه.. "فأما الزبد فيذهب جفاءً، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".
المصدر:الجزيرة