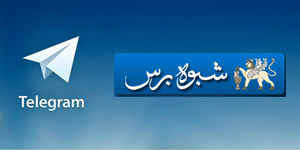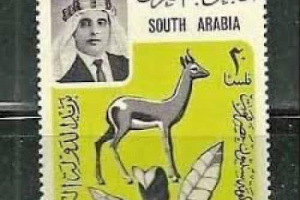اخبار المحافظات
حضرموت التائهة: على هامش ما يشاع عن تولي الجامع البدواني لحقيبة وزارة التربية والتعليم

حضرموت التائهة والمشوهة في مقررات وزارة التربية التعليم
كتب: د. أحمد باحارثة
حضرموت التي يتغنون بتاريخها وثقافتها لكن ذلك غائب عن المقررات التعليمية إلا شيئاً يسيراً، كدرس عن مدينة شبام خصص لها المقرر درساً خاصاً في كتاب اللغة العربية للصف التاسع الجزء الأول، وذكر في ما وصفه بمراكز الحضارة الإسلامية في اليمن بعض المدن اليمنية كان آخرها مدينة (تريم) في كتاب تاريخ الصف الثامن (الجزء الأول).
فإذا اتجهنا نحو التاريخ نجد غياباً لمحطات تاريخية بالغة الأهمية أغفلها المنهج، وهي جزء من تاريخ اليمن العام، مثل إغفال الحديث عن حضارة قوم عاد في الأحقاف، ومثله إغفال ذكر حركة عبد الله بن يحيى الكندي الملقب طالب الحق التي انطلقت من حضرموت إلى سائر اليمن، وإغفال الحديث عن الدولة الكثيرية الأولى مع ذكر الدول اليمنية الأخرى التي ظهرت في التاريخ الوسيط.
لكن واضع المقرر كان شديد التحمس لـ(الدولة القاسمية) مما أوقعه في أخطاء تاريخية واضحة، حيث يقول:
"تمكن الإمام المؤيد من الاستيلاء على صنعاء وكوكبان وثلا وإب، وتمكن أخوه إسماعيل من الاستيلاء على تعز ويافع وعدن ولحج وأبين وحضرموت، وواصل الإمام محمد بن القاسم تعقب العثمانيين حتى تم إخراجهم من اليمن" تاريخ الصف التاسع صـ 90.
فهذه العبارة تصور هؤلاء الأئمة وكأنهم أبطال التحرير وحدهم من غرب اليمن حتى شرقها، وأن الإمام إسماعيل قد استولى على حضرموت بعد أن طرد بني عثمان منها وهذه مغالطة مكشوفة لأن بني كثير هم كانوا المسيطرين حينها على حضرموت وقد أتى إسماعيل إليها بطلب منهم بعد رحيل العثمانيين بربع قرن وليست مطاردة لأجنبي.
ومثله في العصر الحديث والمعاصر إغفال الحديث عن أبرز الأحداث السياسية والوطنية بالمنطقة الشرقية كالحديث عن كبرى سلطناتها وهي السلطنة القعيطية، وما شهدته من تحولات إصلاحية كتنظيم التعليم الحكومي وتأسيس مكتبات عامة لاسيما المكتبة السلطانية أول مكتبة عامة كبرى في اليمن. كما شهد نشوء الوعي الوطني بالمطالبة بتعيين حاكم وطني وطرد الأجنبي، (حادثة القصر 1950م بالمكلا) لكن أغفل هذا الحدث، بل كل الحركة الوطنية في المنطقة الشرقية التي أدت إلى تهاوي السلطنات قبل رحيل المستعمر، ولم يشر لأعلامها.
ولأنتقل إلى الناحية الثقافية والأدبية حيث الغياب شبه التام لثقافة وأدب المنطقة الشرقية لليمن (حضرموت) عن مناهجنا التعليمية فلا يوجد نص رئيس أو عرضي لكبار شعراء حضرموت من مثل أبي بكر بن شهاب، وابن عبيد الله السقاف، وصالح الحامد، وحسين محمد البار، فضلاً عن غيرهم من الشعراء، وما أكثرهم، ومثل ذلك لكبار كتّاب حضرموت كمحمد عبدالقادر بامطرف وسعيد عوض باوزير وعبد الله باذيب ومحمد بن هاشم وقائمة طويلة ممن هم ربما دون هؤلاء كلهم لا تعرف الأجيال الجديدة - أجيال الوحدة - أسماءهم فضلاً عن نماذج من أشعارهم أو كتاباتهم، علماً أنه كان لبعض هؤلاء وجود في نصوص المناهج السابقة قبل الوحدة فقصيدة للحامد في الصف الخامس الابتدائي، وقصيدة للبار في الصف الأول الثانوي، وقصيدة لعبد الله بن علوي الحداد في الصف الثالث الثانوي، أما الكتاب فكان هناك نص لعبد الله باذيب في كتاب القراءة في الصف السابع الابتدائي، ونص لعبد الله سالم باوزير في كتاب الصف الخامس الابتدائي، ونص لمحمد عبد القادر بامطرف في كتاب المطالعة للصف الأول الثانوي، إضافة إلى نص لعلي أحمد باكثير في كتاب الأدب والنصوص بالصف الثالث الثانوي وهو النص الوحيد الذي ثبت في مكانه . هذا مع تجاهل دورهم أو التمثيل بنصوصهم في عرض المدارس الأدبية الحديثة.
ويضاف إلى ذلك تجاهل الشخصيات التاريخية والوطنية الحضرمية أو التي ترجع إلى أصول من حضرموت أو عدم إيرادها مع الأعلام اليمنية والإشارة إلى انتمائها اليمني مثل الكندي أول فيلسوف في الإسلام، وابن باجه الأندلسي وابن يونس المصري والمقنع الكندي الذي عُرّف به دون الإشارة إلى يمنيته، ومثلهم كثير من الأعلام الحضرمية التي لها أدوار في نشر الإسلام في شرق آسيا وشرق إفريقيا، في مقابل الذكر المستمر لأمثال لأبي الحسن الهمداني ونشوان الحميري والملكة أروى من على شاكلتهم.
وقليل هم الحضارم الذي اتسع لهم صدر واضع المقرر، ومع ذلك فإن المعلومات المذكورة عن هؤلاء تأتي منقوصة أو مغلوطة، وكأن هؤلاء غرباء أو أخذوا من مصادر باهتة المعالم، ففي كتاب الصف التاسع من مادة التاريخ أتت العبارة الآتية:
"قبل سلطان الشحر بدر الطويرق طلب الدخول في طاعة العثمانيين".
ألم يقرأ واضع المنهج عن السلطان المذكور أنه سلطان لدولة شملت جميع المنطقة الشرقية لليمن اسمها السلطنة الكثيرية فلماذا حصره في مدينة الشحر وحسب، ثم إن اسمه بدر بن عبد الله الكثيري الملقب أبو طويرق وليس هو (بدر الطويرق) كما أحب أن يسميه، وقد تحدث عنه واضع المقرر وكأنه متخاذل أو خائن.
ومثله (أبو مخرمة) ذكر مع الأعلام اليمنية المؤرخة التي ذكرت بأسمائها الكاملة، أما هذا العالم الحضرمي فقال: "أبو مخرمة مؤلف كتاب ثغر عدن" فيبدو أنه لم يستطع تهجي اسمه على شهره هذا المؤلف وعظمته وهو الطيب بن عبدالله بامخرمة (947هـ).
وكذلك عبدالله علوي الحداد الذي ذكر ضمن مهاجري الحضارم إلى الهند، والأمر ليس كذلك، فهو لم يغادر حضرموت إلا إلى الحج، ومثله عبدالقادر الحضرمي صاحب كتاب النور السافر، واسمه عبدالقادر بن شيخ العيدروس.
وكرر آخر مرتين باسمين مختلفين، فقال مرة أحمد بن حسن الحبشي، وقال في الثانية أحمد بن حسن الحضرمي وهما واحد، ثم ذكر عن الأول أنه أول الدعاة اليمنيين في الحبشة (ص54)، بينما ذلك هو جده الأعلى، وهو أبو بكر بن عبدالرحمن الحبشي المتوفى في منتصف القرن التاسع الهجري، أما هذا فكانت هجرته فقط إلى إندونيسيا وليس إلى الحبشة، وكانت وفاته في مطلع القرن الهجري الماضي.
وابن خلدون تذبذبت المناهج في يمنيته فبينما يُشار إليها عند حديث عابر عنه نجد تجاهلاً لها عندما خصته بالحديث في كتاب مبادئ علم الاجتماع للصف الثاني الثانوي الذي ترجم له تحت عنوان خاص بوصفه الأول في تأسيس ذلك العلم واكتفى بقوله "عالم عربي"، ثم جعل مولده هو عام وفاته (808هـ) ص10، ورغم أنه أشار إلى ريادته تلك مع الإشارة إلى أصله اليمني في كتاب التاريخ الجزء الأول للصف الثامن الأساسي، إلا أنه قد وردت في هذا الكتاب هذه العبارة عند الحديث عن غرناطة التي كانت كما يقول المقرر محطة من محطات هجرة العلامة ابن خلدون، ثم قال بالنص: "وقد كان سقوط غرناطة كآخر معقل من معاقل العرب المسلمين في الأندلس عام 1492م-898هـ، مثار حسرة في نفس ابن خلدون وجميع العرب والمسلمين "، مع أن ابن خلدون حينها كان في عداد الموتى.
وقال واضع المقرر أن لسليمان المهري كتاب (العمارة المهرية في ضبط العلوم البحرية) لكن الواضع لم يضبط العنوان إذ هو (العمدة المهرية) وليس (العمارة).
هذا مثال من التاريخ ولنذكر مثالاً من الأدب في كتاب الصف الثالث الثانوي للأدب والنصوص عند الحديث عن علي أحمد باكثير الذي كان واضع الكتاب متحمساً جداً ليمنيته فهو "علي أحمد بن محمد باكثير الكندي اليمني"، وهو "ولد في أندونيسيا لأبوين يمنيين من مدينة سيئون في حضرموت اليمن" فلم يكتف هذا المؤلف بإثبات يمنية نسبه فأثبتها مرّة أخرى لأبويه!! ثم أثبتها مرة ثالثة لموطنه حضرموت اليمن، وكأن هناك حضرموت أخرى غير حضرموت الواقعة في الجمهورية اليمنية، لكن للأسف مع كل هذا الحماس لباكثير لم يسلم من القصور في تعريفه فهو قد توفي عند المؤلف في القاهرة 1938م مع أنه قد توفي عام 1969م، بل يجهل عنوان مسرحيته الرائدة فأطلق عليه اسم (عاصمة الأحقاف) واكتفى بالتعريف عنها بقوله "وهي منظومة" بينما عنوانها هو (همام أو في عاصمة الأحقاف)، وهي مسرحية شعرية وليست منطومة فقهية، وقد فعل واضع المقرر خيراً عندما تواضع بعدم ذكر عنوان ديوان شعر باكثير واكتفى بالإشارة إليه بقوله: "وله ديوان شعر مشهور" حتى لا يضطر إلى ذكره مغلوطاً أو مبتوراً!!